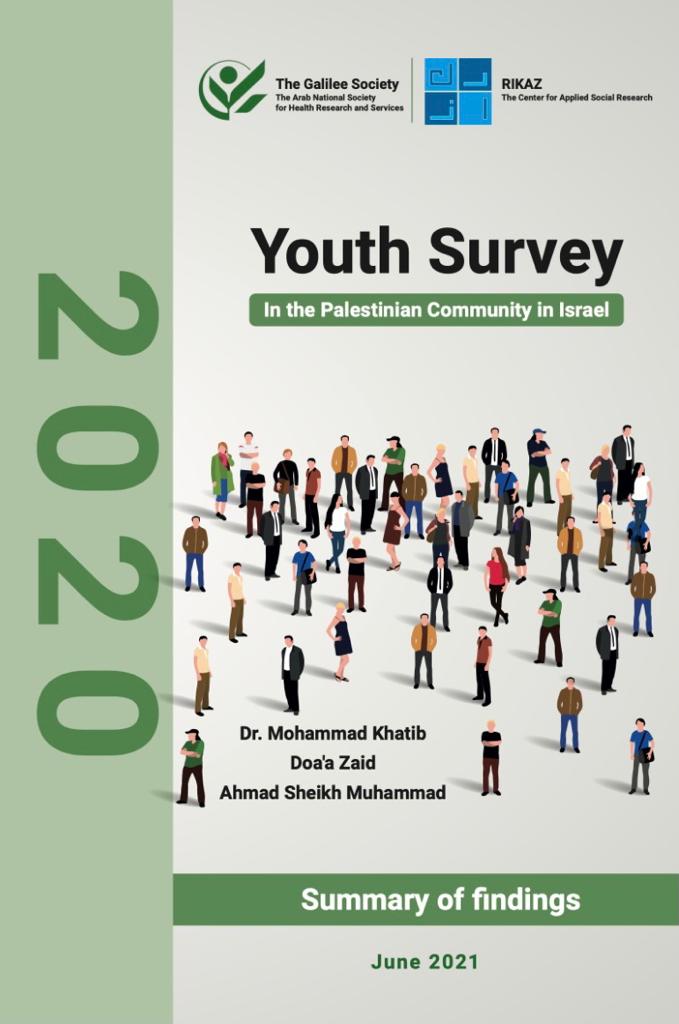09.12.2014
بكر عواودة، المدير العام السابق لجمعية الجليل
تناولت تقارير التنميّة الإنسانيّة للأمم المتّحدة في العقد المنصرم مصطلح “الأمن” من منظور جديد ومغاير للتّعريفات التي تعتمدها الدّول في تعريفها للمصطلح، حيث دأبت الأخيرة على اختزاله وقصره على المخاطر والتّهديدات التي تحيط بكيانها بما تشكله من سلطة وسيادة ومؤسسات، بالأساس تهديدات خارجية من دول معادية في الغالب وتهديدات داخلية تهدد أمن الكيان والنظام، متجاهلة بالقصد والتّرصد أمن المواطن الفرد واستقراره وأمن المجموعات العرقيّة المعرّضة للمخاطر والتّهديدات، جراء سياسات الإقصاء والتّمييز المنتهجة من الدولة نفسها. وفقًا للتّعريف الجديد فإن مصطلح “الأمن الإنسانيّ” ينحو للتّركيز على عقبات تنمية الإنسان وعلى المخاطر التي تهدّد أمنه وكيانه وتحدّ من إمكانيات تطوّره، من خلال توظيف جديد لنظريات الأمن التي تستعملها الدولة وتطبيقاتها القهريّة على الأفراد والمجموعات العرقية.
ولكونه تعبيرًا عامًا وشاملاً، فمن الطبيعيّ أن يحتضن في أكنافه تفسيرات للمعيقات التي تحدّ من قدرة الناس على التّطور والنّماء في مجتمعاتهم ودولهم، فضلاً عن تعرّضهم إلى حالات من انعدام الأمن الفرديّ والجماعيّ بما يختص بوضعهم الحاليّ ومستقبلهم.
بيد أنّه، وعلى الرغم مما ذكر أعلاه حول اتساع نطاقه وأبعاده، فإن مفهوم “الأمن الإنسانيّ” يبقى، بهذا المعنى، توصيفًا تعتوره الكثير من نقاط الضّعف، إذ ينبغي ألا يقتصر على التّشخيص والتّوصيف لأحوال الأفراد والمجموعات بل يتعداها إلى ضرورة بناء إستراتيجيات وبرامج تتمحور في بناء الإنسان وتعزيز وتمكين قدرات النّاس على التّصدي لمختلف التّهديدات والتّحديات التي يواجهونها وإلى أخذ زمام المبادرة في تطوير وتنشئة مقومات التنمية وأسسها.
من هنا فان مهمة تفكيك عالم هذا المفهوم العام إلى مركّبات الأمن المختلفة ستسهل من مقاربته مع الواقع المعاش، ومن فهم أعمق لنوعيّة التهديدات التي تواجه الأقليات الأصلانيّة بشكل عام والمجتمع العربيّ الفلسطينيّ في الدّاخل بشكل خاص، وبالتالي إلى بناء أولويات وآليات للتّعامل مع التّحديات والموانع التنمويّة والتّطويرية البنيويّة للمجتمع العربيّ في البلاد، ومن بين المركّبات التي يجب أخذها بعين الاعتبار والتي يشملها مفهوم الأمن الإنسانيّ:
الأمن الاقتصاديّ: ويشمل انحسار الإمكانيّات المتاحة، الاستغلال الاقتصاديّ، مصادرة الحقوق الاقتصاديّة، انعدام التّجارة العادلة، انتهاج سياسات اقتصاديّة تهميشيّة وإقصائيّة، انعدام التّنمية المستديمة، تثبيت التّبعيّة الاقتصادية، البطالة، تفشّي الفقر.
الأمن الصحيّ: تكلفة الرّعاية الصّحيّة وصعوبة مناليّة الخدمات، انتشار الأمراض المعدية والأغذية غير السّليمة، انعدام المساواة في الخدمات بين الفقراء والأغنياء، انعدام برامج تثقيفيّة حول مستقبل المجتمع العربيّ الصّحيّ، انتشار التّدخين والنّرجيلة .
الأمن البيئيّ: استنضاب الموارد الطّبيعيّة واستغلالها المسيء، التلوث وانعدام العدل والإنصاف في توزيع آثار التّلوث بين القادرين والمعدمين، انحسار العدل البيئيّ بمفهومة الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسّياسيّ، إجحاف التّخطيط، مصادرة الحيّز.
الأمن الاجتماعيّ والأمن الفرديّ: الخوف، والعنف الفرديّ والحمائليّ والطّائفيّ، والعنف ضد النّساء وازدياد الجريمة المنظّمة، وانحسار وتهتك منظومة القيم الاجتماعية فيما يتعلق بالحيّز العام وطغيان حالة اللامبالاة ، وتغليب الشّخصيّ على الجمعيّ.
الأمن السّياسيّ: انحسار الدّيمقراطيّة وتزايد منسوب العنصريّة الممأسسة والشّعبيّة، القمع والملاحقات وغياب التّمثيل الديمقراطيّ للصّالح العام، تضييق هامش العمل السّياسيّ وانحسار إمكانيات التأثير على السّياسات والانكفاء إلى ردود الفعل الاستنكاريّة والتّنديديّة، قولبة المجتمع العربيّ وممثليه السّياسيّين ضمن أعداء وطابور خامس وإقصائهم من دوائر اتخاذ القرار الفعليّ.
الأمن الثقافيّ: تهميش الهوية الثقافية وتهميش الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع الفلسطيني، وإقصاء المثقفين والمبدعين وحظر إنتاجهم الأدبي، وإخفاء المعالم الثقافية واختزالها إلى “مجرّد” فولكلور وذاك في أحسن الأحوال.
الأمن الوجوديّ: وهو ما يتهدّد النّاس من خطر ترحيل وإبعاد، هذا المرّكب يمثّل حالة مستمرّة زاخرة بالنّماذج المرعبة ابتداء من 1948، ولا تزال برامج التّرحيل مستمرّة في القدس وسلوان والنّقب.
لا شكّ أنّ مفهوم الأمن الإنسانيّ سيظل قيد التّطوّر والإنشاء طالما بقيت الحياة الإنسانيّة حاضرة، إذ يمكن أن يتّسع ليشمل أيضًا مفهوم الأمن النفسيّ للإنسان لكونه مركّبًا مهمًّا في بناء استقراره وتطوّره وهو مرتبط بكل المركّبات الأخرى، إضافة للأمن الحياتيّ وهو مفهوم يتعدّى أمن الإنسان المباشر إلى أمن الكائنات الحيّة عامّة ومنظومتها البيئيّة، بحيث يعيش الإنسان في تناغم مع جميع الكائنات الحيّة ويمنع انقراضها وزوالها جراء جموح جشعة.
إن ضرورة فهم الجوانب المتعدّدة لمفهوم الأمن الإنسانيّ المنشود ونقله من عالم التّشخيص إلى ساحات المبادرة والفعل، ليس بالعمل اليسير ولكنه سيسهل بناء تصوّرات وأولويّات في بناء مفهوم الأمن الشّامل كنقطة انطلاق نحو مفهوم تنمويّ متكامل عبر ضرورة توفير حماية لمرتكزات وجود الإنسان وغاياته في المجال السّياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والبيئيّ والصّحيّ والنفسيّ، على أساس ضمان حقّه في الحياة الآمنة والمستقرّة، وحقّه في تطوير هُويّته وكيانه الفرديّ والجماعيّ، وحقّه بالمساواة في وطنه وفي دولته. بمعنى آخر، وضع أولويات لتوفير الإمكانيّات وتمكين قدرات النّاس على الصّمود في وجه التّهديدات والمعيقات المختلفة، بواسطة بناء وتوفير بنى اجتماعيّة وثقافيّة وسياسيّة واقتصاديّة وبيئيّة وصحّيّة وحماية سبل العيش الكريم الآمن والمستقرّ والمستدام .
الفلسطينيّون في إسرائيل؛ واقع مأزوم وأمن مفقود
بحسب مفهوم الأمن الإنسانيّ، فإنّ التهديدات للمواطنين قد تكون قادمة من دولة المواطن نفسه التي يعيش فيها، وخاصّة في حالة وجود نزاعات إثنيّة عرقيّة داخليّة. وفي حالة الأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل، ومنذ نكبة الشّعبّ الفلسطينيّ وفقدانه لقراه ومدنه وأملاكه وإرثه وقيام دولة إسرائيل على أنقاض وطنه، فقد دأبت الدّولة بمؤسّساتها المختلفة على اعتماد سياسات إقصاء مبرمجة ومتعاقبة ضد الأقليّة الفلسطينيّة الباقية في الوطن من أبناء الشعب الفلسطينيّ والتي شكّلت في مختلف مراحل حياتها منذ قيام الدّولة نسبة متفاوتة من 16- 20% من مجمل المواطنين في الدّولة.
وعلى قاعدة اعتبارها إياهم خطرًا أمنيًا إستراتيجيًا على الدّولة (بمفهوم الدّولة نفسها) بحسب تصريحات ساستها ورؤساء أجهزتها الأمنيّة، فقد انتُهجت ضدّ الأقليّة الفلسطينيّة مواطني دولة إسرائيل سياسات تفريغ وتشتيت وإضعاف لكل مقوّمات البناء التّنموي المستديم، أدت بمجملها إلى تشكيلهم كهوامش اجتماعيّة، سياسيّة واقتصادية غير منتجة وغير مؤثّرة وذات تبعيّة تامّة للبنى الاقتصاديّة والاجتماعيّة السّياسيّة والتّربويّة والثّقافيّة في الدّولة، وذلك بعد تفكيك البنى الثّقافية والاقتصاديّة والسّياسيّة والاجتماعيّة التي كانوا يعملون من خلالها قبل قيام الدّولة. وما يميّز هذه الهوامش أنها تسير في فلك السّياسات المنتهجة ضدها ولا تمتلك المبادرة أو المقدرة على إعادة إنتاج وتكوين ذاتها من جديد، أو على بناء مراكز اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة مستقلّة تعمل من خارج حدود السّياسات المرسومة التي تكرّس دونيّة العربيّ وتحرمه من مكوّنات ومستلزمات التّطوّر المستديم.
ضمن هذه الرؤية، فإن انصباب الجهد السياسيّ العربيّ لتغيير وضع الأقليّة العربيّة من خلال محاولة التّأثير على المركز وعلى السّياسات أهمل إمكانيّات البناء الدّاخليّ للأقليّة الفلسطينيّة في كافة الميادين. ولعلّ الجانب التّربويّ التّعليميّ هو خير مثال على ذلك، حيث انكبّ الجهد الأكبر من جهتنا في عمليّة إصلاح جهاز التّربية والتّعليم العربيّ من خلال محاولة انتزاع حقّ إدارة شؤوننا التّعليمية من الدولة، ولكنّنا في المقابل أهملنا كمجتمع العمل مع المعلّمين ومديري المدارس كوكلاء تغيير، من أجل تخفيف آثار السّياسات الحكوميّة، وبالتالي فإنّ فشل المسار الأوّل واستحالة حدوثه ضمن الفرضيّات التي تعتمدها السّياسات من جهة، وإهمال العمل في مسار العمل الداخليّ من جهة أخرى، كل هذا أدى إلى فشل ذريع لجهاز التربية والتعليم العربي قيميًا وتحصيليًًا، وإلى تصاعد حالة النّفور والتّباعد بين ما يمثّله جهاز التّربية والتّعليم العربيّ من واقع تعيس وبين ما يطمح إليه المجتمع العربيّ. الأمثلة كثيرة أيضًا في جوانب أخرى من حياتنا وحراكنا، مثل قضايا القرى غير المعترف بها وقضايا هدم البيوت في النّقب واللّد والمثّلث والجليل فماذا قدّمنا كمجتمع لتمكين قدرات النّاس على الصّمود في أرضهم رغم حالات الهدم المستمرّة؟ هل تمّ بناء آليّات صمود وتمكين للنّاس خلافًا للدّعم المعنويّ. كذلك الأمر في موضوع الفقر والبطالة، فحين يرزح نصف المجتمع تحت خطّ الفقر ويعيش أبناؤه في حالة مستمرّة من الاحتياج وعدم القدرة على شراء احتياجات أساسيّة. ماذا قدمنا كمجتمع للتّعامل مع هذه الظّاهرة الخطيرة ؟
Embed from Getty Images
لا شكّ أنّ الجهود المختلفة التي بُذلت في مواجهة سياسات الدّولة ومؤسّساتها في سبيل إنصاف المواطنين العرب وتحقيق المساواة، كانت مهمّة وقد أثّرت حياة المجتمع العربيّ بكثير من آليات العمل السّياسيّ والقضائيّ، ولكنّها في المقابل لم تؤسّس لعمليات بناء مجتمعيّة تنمويّة مستديمة وشاملة على مستوى القاعدة تقوّي إمكانيّات التّحدي والصّمود لدى المجتمع.
وفي ظلّ الأوضاع الإنسانيّة والحياتيّة الصّعبة التي يعيشها المواطن العربيّ في العقد الأخير، وتراجع إمكانيّات عدالة المنظومة الدّيمقراطية الإسرائيليّة في إنصاف المواطنين العرب، فإنّ الطّموح للمساواة ضمن المنظومة الإسرائيليّة أصبح حلمًا صعب المنال، خاصّة بعد مشاريع تعريف يهوديّة الدّولة وقوانين الموالاة والمواطنة وملاحقة الجمعيّات الأهليّة وإقصاء المواطنين العرب ومحاصرتهم اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، حيث برز تراجع خطير في مكانتهم وفي طرق التّعامل معهم، مما كشف النّقاب عن احتياجات عميقة وأساسيّة للمواطنين العرب تتلّخص أساسًا بالحاجة إلى الأمن وإلى الاستقرار السّياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والثّقافيّ. مفهوم النّضال للمساواة سيبقى فارغ المضمون يراوغ بين جسر الفجوات وكشف الغبن ولجان عمل وتقارير، ولكن بدون معنى تنمويّ تطويريّ ما لم يتطرّق للاحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة التي تخصّ المواطنين العرب في حالتهم السّياسيّة والاجتماعيّة كمجموعة مهدّدة أمنيًّا في كافّة الميادين.
يحتاج المجتمع العربيّ لأن يشعر الأمن والأمان في دولته ومن دولته، ولأن توفّر له مواطنته ركائز وضمانات للأمن بمفهومه الواسع. إن فشل الدّولة في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب من جهة، وضعف المرجعّيات المحليّة والشّعبية والسّياسيّة الدّاخلية من جهة أخرى في توجيه وضبط وقع الحياة الدّاخليّة ومواجهة أزمات العنف المتفشي بين فئات المجتمع والجريمة المنظّمة، أزمات الفقر والبطالة والفساد … كل ذلك أدّى إلى تنامي شعور عام بفقدان الأمن والأمان وفقدان الثّقة على التّغيير وإلى ظهور حالة خطيرة وواسعة من اللامبالاة والاغتراب وقلة الحراك الاجتماعيّ. من هذا المحور يفترض أن تتفرع المطالب الأخرى في المساواة من الدّولة تجاه مواطنيها. وهو المحرّك الاجتماعيّ الداخليّ لبناء ومأسسة بنى هيكليّة اجتماعيّة وسياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة (مثل لجنة متابعة عليا منتخبة، ولجان عمل مهنيّة، مؤسّسات اقتصاديّة، صندوق وطنيّ، شبكة مدارس عربيّة، مركز للعمل التطوعي، إلخ… ) بحيث تمكّن وتقوّي الناس وتوسّع اختياراتهم.
إن أكثر الظّواهر تجلّيا للحالة الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة التي يعيشها المجتمع العربيّ هو تلك الحالة من اللامبالاة والعبثية وقلة الاهتمام للشأن العام وعزوف النّاس وخاصة المثّقفين والأكاديميّين عن أخذ دور حقيقيّ تصحيحيّ جراء تدهور المجتمع العربيّ في كافّة الميادين. فعلى رغم خطورة الأوضاع الاجتماعيّة السّلبيّة المتفشيّة، غير أنّها ظاهرة معروفة تحدث في كثير من المجتمعات وفي أطوار محّددة من حياة الشّعوب، وهي بهذا المعنى قابلة للتّصحيح والتّقويم، ذلك لأنّ هلاك الشّعوب وانطفاء جذوتها لا تحدّده ثُلّة من المجرمين أو المارقين، وإنما قد يتحقّق فعلا جراء التّغاضي المعيب والصّمت المطبق بكل ما يحيط بنا واللامبالاة من قبل السواد الأعظم من الجمهور بمثّقفيه وعامليه. وعندما يغيب الصّوت المسائل والمدافع عن الصّالح العام فهذا يؤسس لبيئة تسود فيها شريعة الغاب وشريعة القويّ وتتضاءل فيها إمكانيات العطاء وإمكانيات التّغيير بل إن هذه البيئة تُعتبر من موانع تأسيس مسيرة التّنميّة المستديمة بكونها تعتمد أولاً على إيجاد بيئة سليمة تمكّن النّاس من استثمار كامل طاقاتهم وقدراتهم بحيث يعيشون حياة منتجة وخلاّقة تتلاءم مع حاجاتهم ومصالحهم.
أحد أهم النّتائج السلبيّة لإهمال البناء الدّاخليّ للمجتمع العربيّ ولحالة اللامبالاة السّائدة كما ذكرت أعلاه، هو فقدان عنصر المساءلة الداخليّ أو الرقابة الداخليّة على عمل مؤسّساتنا. فكثير من حالات الفساد في السّلطات المحليّة تعتبر شأن وزارة الدّاخلية وليس شأننا كمجتمع، فانهيار السّلطات المحليّة العربيّة الواحدة تلو الأخرى يمر من خلال استنكار سياسة الوزارة ولكننا لا ننتقد قلة حيلتنا وصمتنا الرّهيب تجاه الفساد وقلة المهْنيّة في هذه السّلطات. كذلك الأمر في موضوع التّعليم، فنحن نوجّه اللّوم للوزارة بعد صدور نتائج التّقييم الوزاريّ أو الدّوليّ من حيث التّحصيل العلميّ للطّلاب العرب، ولكنّنا لا نملك آليّات عمل مقابل المدارس أو مساءلة المسئولين في تلك المدارس، بل وحتى أن هذه النتائج لا تنشر من قبل المدارس للجمهور وأولياء الأمور وكأن الحديث لا يتعلق بأولادهم.
تؤكّد الحقائق التي نعيشها ضرورة التّعاطي مع عنصر الأمن الإنسانيّ، كضرورة أوليّة أساسيّة لبناء أسس التنميّة في مجتمعنا، فمعظم فئات مجتمعنا تعيش تحت ضغوط سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة تحول دون إقدامهم، خوفًا أو حذرًا، على تطوير قدراتهم وإمكانيّاتهم. محدوديّة الفرص وانعدام الأمن الشخصيّ والجماعيّ وهشاشة البنى الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والبيئيّة، وافتقارها إلى أبعاد تنمويّة ذاتيّة واعتمادها على مصادر خارجيّة أدت إلى ضعف عام وإلى تعثّر عملية التّنمية المجتمعيّة، ومن هنا تكمن أهميّة الطّرح الدّاعي إلى أهمية إحداث تغيير على المستوى الدّاخليّ أوّلاً من خلال الإيمان بقدرات الناس على إحداث التّغيير.